
في فلسفة للتشريع الإلهي
«الدين وهم» «الدين أفيون الشعوب»….
قد تعترض جهتان على هذا السؤال. جهة تفصم بين الفلسفة و الدين «الدين وهم» «الدين أفيون الشعوب» «موت الإله» و أخرى بين الدين و الفلسفة «من تمنطق فقد تزندق».
و كلاهما، في نظري، جهتا نقل لا عقل، تنقلان موروثا باسم الفلسفة أو باسم الدين نقلا دوغمائيا.
غير أننا نجد المشروعية لهذا السؤال من القرآن و من الفلسفة. فالقرآن يحث على التأمل و النظر و التعقل و التدبر و العلم في طلب الحقيقة و في الاحتجاج له او ضده. و الفلسفة الأصيلة بحث عن الحقيقة و عن المبادئ التي بها تنتظم حركة الفكر و الوجود و عن الحكمة في ذلك. فإذا كان الفارابي قد بين بأن الفلسفة خادمة للدين تبرهن و تستدل على ما فيه من حكمة نظرية أو عملية، و كان ابن رشد يوافق بين الحكمة و الشريعة من حيث الطريقة و الغاية، فإننا نتصور فلسفة للتشريع في القرآن مثلا تستنبط منه المبادئ التي على أساسها يقوم التشريع الرباني و التي من خلالها يتيسر و يتوجه التشريع البشري في القضايا و الأمور المستجد في السياسة و الاقتصاد و الاجتماع و يتوجه سلوك الإنسان و وجوده الكلي.
و لنتدبر معا مفهوم الحدود في القرآن لنتبين معناه و دلالته و نستنبط المبادئ التي تقوم عليها الحدود.
ترتبط الحدود في القرآن بمفهوم الحق. سواء حق الفرد أو حق الغير. ففي آيات الصيام في سورة البقرة يشرع الله للمؤمنين ” يا أيها الذين آمنوا” كتاب الصيام “كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم”. و الصيام هو منع النفس من حقها في الأكل والشرب و مباشرة النساء في نهار سواء في رمضان أو في غيره من الايام. “وكلوا واشربوا. حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر…” “أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم”. و هذا الكتاب له حدود “تلك حدود الله فلا تقربوها” تمنع المؤمن و تحجز صيامه في إطارها. يتعلق الأمر بحدود زمانية (شهر رمضان، النهار و ليس الليل) و مكانية ” ولا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد” و حدود تتغير بتغير أحوال الفرد (المسافر و المريض) و( الذي يطيقه).
تقوم هذه الحدود على مبادئ ثلاثة هي: الحق و الخير و العلم. الحق في الرغبات التي تكفل البقاء و ما يستند عليه ‘”و ابتغوا ما كتب الله لكم”. و الخير ” و ان تصوموا خير لكم” و العلم “إن كنتم تعلمون”. و الحق تابع للخير و الخير متعلق بالعلم. ذلك أن الإنسان مدعو إلى ابتغاء حقوقه في حدود ما هو خير له و ما يدل عليه العلم بحسب المقام.
و عليه فحقوق الأفراد مشروعة بشرط أن تحتكم إلى الخير و العلم. فكل تشريع يستجد لابد له أن يلتزم بهذه المبادئ الثلاثة و إلا وقع التعدي. الاعتداء على النفس و على الغير في حقوقه المالية (الإرث) و في حقوقه الاجتماعية (الطلاق).
وقد بينا في تدوينة سابقة أن الخيرية مبدأ يقوم عليه التشريع الإسلامي “إن الدين عند الله الإسلام” (سورة آل عمران). فما هو الخير؟
يقوم منهجنا في تحديد المفاهيم على تأصيلها اللساني “وإنه لتنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين”، لإدراك معناها النووي أولا، ثم نعكف على بيان دلالاته في سياق الآيات القرآنية و نستنبط في الأخير المبدأ العام أو القاعدة المجردة التي يقوم عليها.
فالخير مصدر من فعل “خار”، نقول “خار الله لفلان في الأمر”، أي جعل له الخير فيه. (الكليات، أبو البقاء الكفوي). و “خار الشيء على غيره، فضله عليه”. و منه فأن يجعل الله لك في الأمر الخير، يفضله لك على ما سواه.
ترد كلمة الخير في سياقات مختلفة في القرآن الكريم تدل على أمور الخير الممكنة:
أولا، في أن الخير في الاهتداء بالحس السليم و قتل ما تأمر به الأنفس؛
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤ البقرة﴾
فظلم النفس (تأليه غير الله)، فيكون الخير في التوبة إلى البارئ، الخالق ب”قتل” النفس (منعها من الشرك). فالخير هنا مقرون بالتعقل و عدم الميل مع أمر النفس لما فيه من بؤس “قل بئس ما يامركم به إيمانكم” وتعارضه مع الحس السليم. “وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨ الأعراف﴾ إذ كيف يتخذ من المادة المصنوعة (الحلي) لا “تكلم” “و لا تهدي” عجلا يعبد بديلا أو بمعية الله البارئ الذي يكلم الناس “وكلم الله موسى” و يهديهم إلى الفلاح “وإذ أتينا موسى الكتاب و الفرقان لعلكم تهتدون”
ثانيا، في أن الخير في طلب الأعلى على الأدنى
“أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، و ضربت عليهم الذلة و المسكنة، و باءوا بغضب من الله”. أي أن الخير متعلق بأمور تعز فيها النفس و تكرم، و ليس في أمور تدنو بها و تسفل. ذلك أن بني إسرائيل و هم في طريق النجاة و الحرية بعد أن كانوا أذلاء مستصغرين عند فرعون وقومه “و إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبنائكم و يستحيون نسائكم، و في ذلكم بلاء من ربكم عظيم”، غلب عليهم طبع العبيد الذين تذلهم نفسهم الشهوانية فيرون في الحرية ثقلا يصعب تحمله. فالخير إذن في الصبر على الحرية و لأجل الكرامة لا في طلب الذلة و المسكنة؛
ثالثا، في أن الخير هو التزكية و الحكمة و العلم
و الخير هو الذي به يفضل الأقوام أو يساوون غيرهم. وهكذا الأمر فيما يتعلق بأمة القرآن التي ستفضل بأن تكون أمة كتاب “هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين”. وبين أن الخير الذي هو الغاية من بعثة رسولنا الكريم هي تلاوة آيات الله و التزكية والعلم و الحكمة، و التي بها يتحقق لهم الاهتداء و الخروج من الضلالة. و لأن من سبقهم من أهل الكتاب يعرفون أهمية هذا الخير فإن الكافرين منهم و المشركين “ما يود الذي كفروا من أهل الكتاب و لا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم و الله يختص برحمته من يشاء”. ذلك أن الرحمة هي جلب الخير، في مقابل الرأفة التي هي دفع الشر.
رابعا، في أن الخير في الامتثال لأمر الله
أي ما أمر به الله المؤمنين من إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة والحج و الصيام و أمور الإنفاق والقتال والإصلاح لليتامى و النكاح (سورة البقرة الآيات 110، 184، 197، 216، 220) و حسن التصرف في الصدقات و القروض “وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة” (البقرة آية (280. وبين أنها أمور يفضل بها حال المؤمن في ذاته و في مجتمعه، فهي تطال جوانب الحياة على اختلاف أبعادها. فلا أحد من الحكماء أو الفلاسفة ينكر أن السمو الروحي و الإحسان و التحكم في الشهوات و القتال ضد الظلم و رفع المظالم و التيسير على الناس من أمور الفضيلة و الخير.
خامسا، في أن الخير بيد الله
فقد يظهر للناس أن أمورا تتنافى مع الخير من جهة تصورهم و حكمهم و تقديرهم فيما يتعلق بإيتاء بالملك أو نزعه، و العزة أو الذلة و المكر و الأمور المتعلقة بالظواهر الكونية و الحياة و الموت، لكنها خير في تدبير الله بما أنه “مالك الملك”، “على كل شيء قدير” ، “يرزق من يشاء بغير حساب” و هو “خير الماكرين”.
سادسا، في أن خيرية أمة الإسلام متعلقة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر”.
و متى خرجت عن ذلك انتفت عنها صفة الخيرية و انتقلت إلى أمم غيرها. و المعروف اسم لكل ما “يعرف حسنه بالعقل أو بالشرع” قولا أو فعلا، و المنكر اسم لكل قول أو فعل يعرف قبحهما بالعقل أو/و بالشرع. و كلاهما متعلق بالمعرفة القائمة على التدبر و الحس السليم. “قول معروف و مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى” (البقرة 263)، “كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر. و لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون، و أكثرهم الفاسقون” (آل عمران، 110)
سابعا، في أن الله يثيب الناس على ما فعلوه من خير وإن اختلفوا في الشرعة و المنهاج والوجهة
ففي غير ما آية يؤكد الله عز و جل بأن فعل الخير لن يكفره الله مطلقا “و ما يفعلوا من خير، فلن يكفروه، و الله عليم بالمتقين” (آل عمران، 150)، “فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فلا كفران لسعيه و إنا له لكاتبون” (الأنبياء، 94). و الأمر لا يتعلق بأمة القرآن بل لكل الناس. و لذلك، كان استباق الخيرات هو الأمر الذي به تتفاضل الأمم و الأفراد في الدنيا و الآخرة. “ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا” (البقرة، آ. 148). وهذا بيان بأن الناس تختلف وجهاتهم، لكن الأمر بينهم لا يتعلق بأفضلية هذه الوجهة أو القبلة على تلك، و إنما الأمر بينهم يتعلق باستباق الخيرات. و هذا ما يؤكده عز و جل في قوله “ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب، و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملائكة و الكتاب و النبيئين، و آتى المال على حبه ذوي القربى و اليتامى و ابن السبيل و أقام الصلاة و آتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا و الصابرين في البأساء و الضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون” (البقرة، 177).
هذه الدلالات السبع لمفهوم الخير في القرآن الكريم الذي هو منتهى التشريع الإلهي و منطلق التشريع البشري في الأمور المستجدة و المتغيرة تجتمع حول فكرة واحدة هي ما يتفاضل فيه الناس في وجودهم كأفراد و جماعات، كأمم و ملل، هو سعيهم إلى الخير و فيه. لذلك فكون القرآن الكريم منتهى الخيرية فكل تشريع يوافق مبدأ الخيرية هو تشريع إسلامي مطلوب وضروري.
ملاحظة: الإسلام ليس قصرا على أمة القرآن. يقول الله عز وجل في سورة البقرة ” أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك و إله آبائك إبراهيم و إسماعيل و إسحاق، إلها واحدا و نحن له مسلمون)
عبد السلام أولباز، اكادير، 19 رمضان 1445، الموافق ل 30 مارس 2024)

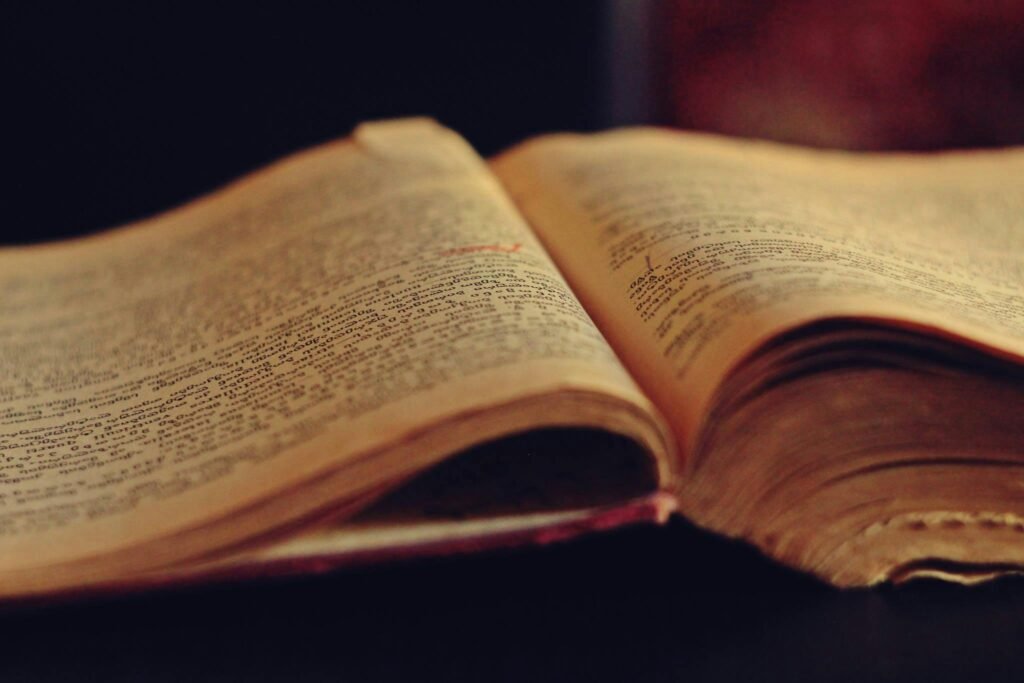
No responses yet