يقدم هيجل فلسفته كثيوديسا، كخطاب فلسفي حول وجود الله و العدالة الإلهية. ثيوديسا من ثيوس theós)): الإله و ديسا (díkê): العدالة.
«حديث الثيوديسا» بدأه لايبنز في مناظرته غير المباشرة مع صاحب «المعجم التاريخي النقدي» بايل (نشر لأول مرة بين سنتي 1696 و 1697) ومناظرته الشهيرة مع البروتستانت لوكرك و … تقوم أطروحة بايل على أن العقل والإيمان متعارضان و على العقل أن يخضع لأن مبادئه الكونية والميتافيزيقية و الأخلاقية الضرورية وقوته على الاستدلال، من مقدمات عقلية وغير عقلية تلزم عنها نتائج (أحكام، معتقدات، مشاعر) مصدر للشك و الخطأ ومنتج للمعضلات والأزمات. ومهمة الفلسفة تكمن، فقط، في تبرير النتائج السخيفة للعقل الذي تحركه دوافع لا- عقلانية ومتناقضة. أي أن العقل لا يقود إلى الحقيقة بالضرورة مقارنة بدور الوعي (الإرادة و القلب) والفطرة.
ينتقد لايبنتز مفهوم العقل عند بايل. فالعقل ليس هو القدرة على الاستدلال الحسن أو السيء أو «مجرد آراء واقاويل وعادات حكم». العقل عنده علاقة تربط بين حقائق يقينية وحقائق ظنية نوافق بها على الحقائق الظنية. وهذا يعني أن كل الحقائق، بما فيها الحقائق الدينية، تندمج، منطقيا و ميتافيزيقيا، في مفهوم كلي للحقيقة. وهذا يعني أن الحقيقة «العقلية» و الحقيقة «الدينية» يفترقان نسبيا. فالعقل يطلب التعليل والتفسير (المعرفة بالأسباب: كيف و لماذا؟) وهو ما يمتنع في الحقائق الدينية («المسيحية»)التي علينا أن نؤمن بها بدون معرفة بكيف أو سبب. وهذا لا ينفي عنها صفة الحقيقة لأنها متضمنة في العقل الكلي. فهي بهذا التضمن عقلانية بالضرورة. وكل تشكيك في توافق الحقيقة الدينية مع الحقيقة العقلية (الممكنة بشريا) يعني التشكيك في توافق العقل الكلي مع ذاته.
يتوافق العقل الكلي مع العقل البشري صوريا يقصر الاختلاف بينهما إما في ما هو خارجي: كيف تشكل الحقائق أو ما هو ذاتي: نوعية الحقائق: الأزلية والموضوعية والطارئة و الواقعية…
وبخلاف ابن رشد و مارتن لوثر اللذين يفرقان بين خطاب الحقيقة الديني وخطاب الحقيقة الفلسفي، يتفرد موقف لايبنز معتبرا بأن الحقيقتين معا ينتميان إلى ذات النسق الابستيمي: نسق العقل الكلي. ويؤول الفرق بينهما إلى الفرق بين ما يقبل الفهم و البرهنة وما يمتنع عن ذلك. والشرط الوحيد الوحيد لوحدة الحقيقة هو امتناع التناقض الخارجي والداخلي وإمكانيتها المنطقية و الميتافيزيقية.
لكن كيف للعقل البشري أن يطمئن إلى الحقائق المنزلة بدون أن يناقض منطقه في الحكم ومنهجه في الاستدلال؟
يميز لايبنز بين مجموعتين من الحقائق: الحقائق الأزلية و الحقائق الموضوعية. فالأولى ضرورية منطقيا وميتافيزيقيا توقع مناقضتها في التناقض والسخافة، و الثانية ، وهي «مختلف القوانين التي قضاه الله في الطبيعة والتي لا تقبل التعطيل إلا بأمره» ضرورية أخلاقيا بما أن الله اختارها وفق مبدأ «الأفضلية»و التي بها يكون هذا العالم هو أفضل العوالم الممكنة.
لذلك، فالحكم بعجز العقل عن الفهم و البرهنة على حقائق الدين التي تمتنع عن التصديق بواسطته حكم لا يفرق – كما يفعل بايل- بين عمليات الفهم والتفسير والإثبات والاتباع، من جهة، وبين أمرين: ما فوق قدرة العقل و ما ضد العقل. والحال أن الثيولوجيا يقوم منهجها على التفسير لا على الفهم، و على الاتباع لا الإثبات.
تفسير الشيء يعني تبين معناه لإدراك موضوعه. فالتجسيد المسيحي مفاده أن الله اتحد بالطبيعة البشرية محتفظا بطبيعته الإلهية. وهو ما يمكن قياسه على اتحاد الروح بالجسد لتكوين فكرة عن معناه(«س» بالنسبة ل «ص» يقارب نسبة « أ» ل «ب»). ولا يمكننا أن نتعدى حدود التفسير لنفهم حقيقة التجسيد والكيفية التي تم بها. ففهم الشيء يكون ممكنا فقط إذا امتلكناه وشهدنا حقيقته ودريناه بوضوح وتميز وهو أمر يمتنع ويستحيل فيما يتعلق بالحقائق الدينية.
وكما يستحيل الفهم تستحيل البرهنة على الحقائق الدينية و تحديد أسبابها القبلية. وبالمقابل، يمكننا أن ننقض الاعتراضات الصورية ضدها بأن نبين عدم تناقضها – إلا في الظاهر- مع مبادئ المنطق و الميتافيزيقا.
كيف لنا أن نتبع ما لا نفهمه؟
يرتبط الأمر بمقدمة ضرورية. فبمجرد أن يتأكد لنا أن الكتاب المقدس وحي إلهي، تصبح الحقائق التي يدلنا عليها غير قابلة للنقض. وكل اعتراض يجب أن يفند وإلا صدقت القضية و نقيضها. وهذا أمر مستحيل منطقيا. فإما أن نفند الوحي ونبين تهافته وإما أن نفند الاعتراض ببيان تهاتفه وسخافته واستجابته فقط للظواهر الطارئة والوقائع والاعتبارات الطبيعية.
لا يتعلق الأمر بالبرهنة العقلية على حقيقة الوحي فهو لا يقبل البرهنة مثلما لا يقبل الفهم، وإنما بالحكم على صحة الاعتراضات و صلابة حججها . وهو أمر لا يحتاج، في تقدير لايبنز، إلى إلإلمام العميق بقضايا الدين بقدر ما يستلزم معرفة وتوظيف المنطق وقواعده العامة.
«[…] يستطيع الرجل النبيه الذي يستعمل القواعد المنطقية العامة أن يرد على أقوى الاعتراضات العقلانية المزعومة ضد الحقيقة الدينية […] علينا فقط، أن نفحص الحجة باتباع القواعد المنطقية، فنحكم على تناقضه الصوري وتهافت مقدماته»
نفس الأساس يسعفنا لإدراك توافق الدين مع العقل الكلي والرد على ما يتعارض مع العقل البشري الذي يعجز عن فهم ما هو خارج نطاق قدرته ولكنه يستطيع تمييز ما يعارضه ويناقض منطقه ويثبت بالدليل خطأه.
«إن حقائق الكتاب المقدس فوق قدرة العقل… ولكنها لا تتعارض معه. ذلك أن العقل البشري يختلف عن العقل الكلي الذي عند الله. هذا الأخير، يكون دائما على صواب وحقائق الكتاب المقدس ليست، مطلقا، لا فوقه و لا ضده، بينما يتعذر على عقلنا البشري ان يدرك هذا التوافق. والحال أن ما لا يتوافق، في الظاهر، مع عقلنا يبدو لنا مستحيلا مثلما يظهر لنا ما لا يخالف الحقيقة معارضا لها»
يفرق لا يبنز، على هذا الأساس، بين ما فوق العقل و ما ضد العقل. والتفريق بينهما ضروري فيزيائيا وهندسيا ليتميز ما هو ضد الحقيقة الأزلية وضد العقل، أي ما يستحيل منطقيا و ميتافيزيقيا، عن ما هو فوق قدرة العقل الذي «يتنافى، فقط، مع ما اعتاد الناس تصوره وتجربته» و ما هو مستحيل بالنظر إلى الثواني الفيزيائية. وبناء على هذا التفريق، يكون الاختلاف بين العقل الكلي والعقل البشري اختلافا في الدرجة لا في الطبيعة «اختلاف قطرة الماء عن محيطها، و اختلاف المتناهي عن اللامتناهي». وبذلك، فما لايستطيع العقل البشري أن يفهمه أو يثبته لا يتناقض مع مبادئه ومقولاته. فيكون توافق العقل الكلي و العقل البشري مؤكدا من غير ما حاجة إلى الفهم الكامل للعقائد المسيحية التي تنتمي إلى نفس سلسلة الحقائق التي يمتنع فيها التناقض المنطقي و الميتافيزيقي. وكل الاعتراضات العقلانية الموجهة للدين تقبل الحل بالضرورة بما في ذلك مسألة الشر الذي يعتبره الكثيرون الحجرة التي تتعثر أمامها جميع الثيولوجيات العقلية.
تتولد عن وجود الشر مفارقة يصوغها السؤال التالي: إذا كان الله موصوفا بالكمال و الخير، ألا يتعارض وجود الشر مع كماله وخيريته؟ لماذا لا يمنع الله الشر؟ لماذا يعاقب فاعله بدل إغاثته؟
قد يجد العقل البشري إزاء مسألة الشر بإزاء حلين يشتركان في نفي التوحيد: المانوية أو الإلحاد: القول بوجود عالمي الخير/النور/الله وعالم الشر ونسبته إلى الإنسان ومن قم تبرئة الله من الخطيئة الأولى، أو القول بسخافة الاعتقاد بوجود كائن كامل و يفعل الشر.
في القسم «المذهبي» لمقالته عن العدالة الإلهية، يبرر لايبنز وجود الشرر بمقدمات:
- إثبات المسافة بين الله و الإنسان ورد المقارنات الأنتربومورفية التي تقيس الفعل الإلهي بالفعل البشري و تساوي بين الوجودين في حق التقاضي والترافع. والحال أن المقامين غير متناسبين من حيث المعرفة بالحقيقة. إذ يغلب على ادراك الإنسان الظن والحكم يتحدد تبعا للقرائن والاحتمالات والتخمينات والأحكام القبلية. لذلك، فمؤاخذة الله، في غياب اليقين، غير ممكن ، كما أن ثقتنا في كماله يمنعنا من الترافع ضده بقرائن ظنية؛
- لما كان العقل والوحي هبتان من الله، فإن خلق التعارض بينهما يعني خلق التعارض بين الله وذاته ، مثلما أن كل غلبة للدين على العقل تؤول ضرورة إلى غلبة العقل على الدين. وهذا يعني أن التعليلات الواهية و الأحكام القبلية و المظاهر هي التي تتنازع الغلبة فيما بينها.
- تصدم حقائق الدين عادات الناس في فهم الأمور وقبول الأشياء. لذلك، يتعذر فهمها ويكفي أن ندع العقل يكمل عمله البناء- لا الهادم- ف « سيعدنا بامور عميقة حين نتبعه، برغبة ملحة في البحث وإظهار الحقيقة ،إلى حيث يسير».
- إن الله وقد خلق الكون بحكمته وقدرته وإرادته محب للعدالة والخير؛
- امتناع التنافي بين العلم الإلهي وقضاؤه مع حرية الإنسان ومسئوليته على أفعاله؛
- أن الخطيئة تشكل جزءا من نظام يهتدي به الوجود قدره الله بمقتضى مشيئته العقلانية، فهي عنصر في النظام، الله غير مسؤول عنه؛
- عندما ندرك بأن الشر شرط في نظام العدالة-الحق كما شٍيء من الله، سندرك بأن الله منزه عنه؛
- ان العالم يهتدي بنظام محدد قبليا في انسجام مع الخير والعدل الإلهي، ولا شيء فيه إلا ويتحرك بمقتضى هذا النظام القبلي. إذ في غياب هكذا شرط يفسد العالم ويمتنع وجود النظام فيه؛
عن هذه المقدمات تترتب النتيجة التالية:
إن الشر شر في الظاهر وليس في الحقيقة و يندرج في سيرورة تتجه نحو غايات خيرة بالضرورة. و بما أن الله خير وعادل فكل فعله خير وعادل بالضرورة.
ثيوديسا لايبنز وثيوديسا هيجل
يقدم هيجل فلسفته على أنها ثيوديسا مبرزا، في نفس الوقت، اختلافه عن لايبنز. «[…] صحيح أن ملاحظتنا بمثابة ثيوديسا، تبرير لوجود الله، مثلما حاول لايبنز ذلك بطريقته ميتافيزيقيا و بمقولات مجردة غير واضحة».
غالبا ما اعتبرت الهيجيلية فلسفة تستعيد استدلال لايبنز الذي يبرز فيه بأن الشر له سبب وجود كافي و يترتب عنه بالضرورة خير أسمى. فمملكة التاريخ عند هيجل لا يفقد فيها شيء، ولا شيء فيها يتم بدون جدوى». ومع ذلك، فثيوديسا هيجل يختلف استدلالها عن استدلال ثيوديسا لايبنز. فالشر بالنسبة لهيجل ليس مجرد شرط ضروري للخير يفرضه منطق البحث عن الأمثل، بل هو أمر اقتضته المشيئة الاهية لأجل غايات توافقها ، وتتحقق بوسائل إلهية. أي أننا ننتقل من ثيوديسا تفترض بأن الشر يفرض نفسه على الله، وفقا للايبنز، إلى ثيوديسا تقترض بأن الشر من اختيار الله. بنضاف إلى هذا الاختلاف اختلاف في تصور الخير والشر بما أن كل ما هو «موجود» مشروع في فلسفة هيجل، غير أن هذه التأويلات لم تأخذ بعين الاعتبار، بحسب جيل مارماس ، أصالة موضوعة السلب في فلسفة هيجل. وعلى هذا الأساس يفترض بأن:
أ) الشر ليس سبب موجبا للخير وإنما ما «ضده» يأتي الخير. فهو ليس إلا وسيلة على سبيل العرضية و الجواز لا السببية و الضرورة؛
ب) لا يمكن للشر -للمتناهي والطارئ – منع الخير- الحرية و المصالحة. بالنسبة لهيجل، فكل مرحلة من مراحل التاريخ، مهما اعتورها من نقص وشهدته من مأسي، هي من عمل الروح. وعلى الفلسفة أن تتعرف في سياق التاريخ على سيادة الروح فيه؛
ج) ومع ذلك، فالشر لن يختفي لأن انتصار الخير عليه انتصار في مستوى الفكر دون الواقع.
نتساءل بناء على هذه الفرضيات: ماهو موقع الشر في فلسفة هيجل؟
القصور معطى بنيوي في تطور النسق. فكل مرحلة من مراحله يشوبها نوع من التجريد والتناقض. إذ قد يبدو بأن مرحلة ما تحل القصور الذي في المرحلة قبلها، ومع ذلك فذات المرحلة ستكون شكلا جديدا للقصور. تعري نصوص هيجل ظلم البشر ومآسي التاريخ: يدين هيجل، مثلا، بطش الدولة الرومانية وفساد الكنيسة في القرون الوسطى.
«عندما نتأمل مشهد الأهواء وعنفها، وسذاجتها، وعلى الخصوص سذاجة ذري النيات الطيبة و الأهداف العادلة ؛ عندما نرى بأم أعيننا الشر والخبث و إبادة الشعوب والدول النبيلة واندثار الممالك المزدهرة التي أبدعها العقل البشري، فلا يسعنا إلا أن نترح ونحزن لمعاناة الأفراد ونتألم لفظاعة مشهد لم تنتجه الطبيعة بل إرادة البشر».
يظهر مع هيجل، مقارنة بلايبنز، شر من يختلف عن الشر الطبيعي و الأخلاقي و الميتافيزيقي. فهيجل يأخذ بعين الاعتبار معاناة و موت الأفراد و الدول الكبيرة والنبيلة. هذا التناقض الصارخ بين ما يستحقه صناع التاريخ و مصيرهم الفظيع.
ومع ذلك، فالفيلسوف لا يركن إلى تاثير هذه الصورة الخاصة في نفسه، وعليه أن يدمجه ، من خلال تأملاته، في نظرة شمولية.
أساسا، يقترن الشر، عند هيجل، بالتناهي، بالموجود المحدود بغيره. يكون الكائن متناهيا عندما بتعلقه بالأخر في نمط خاص ، غير كوني، أي عندما يمارس عليه العنف أو يمارسه الآخر ضده، مما يدل على تعذر المصالحة مع الأخر وعلى غيرية لا تلائم أي طرف. يتناهى الشيء لأنه يكون مفعولا به منفعلا بالتغيرات الخارجية عوض أن يكون فاعلا وضامنا لوحدته بنفسه.
تأتي وضعية التناهي الدالة على عدم المصالحة، عند هيجل، أولا و تأتي وضعية اللامتناهي : «ما عندي هو لدى الآخر» أو الذاتية المعينة لها. فالتناهي إما أن يكون بداية فورية لدورة منتظمة وإما أن يكون النفي الأولي لهذه البداية، (لحظة الخصوصية و القطيعة).
الشر البدئي أمر واقع بلا تفسير في حين أن الشر، في اللحظة الثانية، في دلالته على الخصوصية و القطيعة، تفسره اسباب موضوعية بدون أن تبرره. يتناول هيجل في الحاشية 139 من «مبادئ فلسفة الحق»، دورة الإرادة التي تبدأ بصورة أولى هي صورة الإرادة الطبيعية والبريئة لطفل أو إنسان جاهل، تعقبها صورة ثانية للإرادة، الإرادة المندفعة بأسباب موضوعية.
ليس المتناهي في فلسفة هيجل معطى أنطلوجي. المتناهي، في نظره، معطى بنيوي . فهو، من جهة أولى، يميز اللحظة الأولى والثانية لأي دورة منتظمة ، وكل لحظة، من جهة أخرى، تتقاطعها دورات متعددة: الدورة البدئية أو الخصوصية أو دورة الذاتية الملموسة. فالأسرة مثلا يتقاطع في تكوينها العقل المطلق والعقل الموضوعي والحياة الأخلاقية. فهي غير متناهية كعقل مطلق و متناهية كعقل موضوعي وغير متناهية، من جديد، كونها حياة أخلاقية ومتناهية باعتبارها لحظة فورية للحياة الأخلاقية. الأسرة خير من حيث انها حرة في جوهرها (عقل مطلق) و قاصرة في تعددها (عقل موضوعي) ، خير كمؤسسة قائمة على إرادة مشتركة (حياة أخلاقية) لكنها سيئة لأنها لا تقوم إلا على الشعور لا على اختيار حر (فورية الحياة الأخلاقية)… على هذا الأساس، فإن حضور الخير و الشر نسبي وتناوبي بين دورات لحظة بذاتها.
قد يعني هذا أن الشر بالنسبة لهيجل مجرد وسيلة . كأن نفترض بأن لحظة العالم الروماني (العنيف افتراضا) كانت ضرورية لظهور لحظة العالم الجرماني (التحرييري افتراضا). مما قد يعني بأن الروح خلق العالم الروماني لأجل العالم الجرماني. غير أن هذا الاستدلال لا يتبناه هيجل. فاللحظات التاريخية لا ترتبط فيما بينها بعلاقات سببية وإنما بعلاقات قائمة على التعارض . فظهور العالم الجرماني سيتم بالقطع مع العالم الروماني و لم يفرض نفسه إلا بعد سقوطه. علاوة على أن العالم الروماني، شأنه شأن جميع السيرورات المنظمة مكتف في بقائه بذاته. يمكن للعالم الجرماني أن يتوسل باللحظة السابقة عليه كشرط سلبي لوجوده. أي كشرط يسمح له بإثبات نفسه. فليس الشر وسيلة للخير إذن. فعندما يهيمن الشر لا يتراءى أي خير في الأفق. أما بالنسبة للخير، فله أساسه في ذاته و يتطور ضد الشر.
هل مجرى التاريخ يتجه، حسب هيحل، يتجه بالضرورة نحو نهاية ضرورية وأن مختلف لحظاته ترد لأجل هذه النهاية؟
لو أن الأمر كذلك، فالقول بالفورية و القطيعة بين اللحظات و الدورات لن يكون ممكنا. إذ ستحتاج الفورية إلى وسيط والقطيعة إلى مبدأ وحدة. ستكون قراءتنا للنسق الهيجيلي خاطئة انطلاقا من فكرة اللحظة النهائية بالنظر إلى أن النسق المنتظم نسق توليدي. ففي فترة الاستبداد في الشرق لم يكن خلاف هذا الاستبداد الذي تشكل فوريا كأمر واقع ليس كوسيلة للمرحلة الملكية التي ستعقبه. وبالمثل، فإن العالم الإغريقي- الروماني لم يكن استجابة وحلقة وسيطة لظهور العالم المسيحي. فالشر عند هيجل لا يقبل المسامحة.
تؤكد الهيجلية بأن الكلي، أي ما له مشروعية ذاتية، يفرض نفسه و ينتصر دائما على الجزئي الذي يوجد بغيره لا بذاته. فنعث الثيوديسا يصدق على الهيجلية لأن الكلمة الختم والظهر تكون للامتناهي (الذاتية الملموسة: أنا و الغير لدينا نفس الشيء) في نظرها والمتناهي يكون تابعا له.لا تعني ثيوديسا هيجل بأن الشر غير موجود أو مهمل بالعلاقة مع الخير الذي يصاحبه أو أنه يساهم في الخير الأسمى، ولكن الشر يهزم. وهذا ما يفيده مفهوم الإلغاء Aufhebung: بديل الفورية و القطيعة في سيرورة النسق. اللاعدالة في اطروحة هيجل أمر لا يمكن تجاهله ولكن الطرد والإبطال قدرها.
هذه المصالحة لن تتحقق إلا بمعرفة الموجب الذي يختفي فيه السلبي ويتجاوز. فالعدالة دليل على بطلان المتناهي. لذلك، فمآل التاريخ مزدوج: إذ ستفقد الأنظمة التي لا أساس لها تفوقها و قوتها، من جهة، و ستظهر الأنظمة القائمة بذاتها، أي التي تقوم على إرادة كونية محايثة. وزيادة على ذلك فإن اجثثات الأنظمة غير العادلة من طرف الأنظمة العادلة أمر عادل.
لكن، هل هذا يعني انتهاء الشر ؟ بأي معنى يكون الإلغاء ممكنا؟كيف يمكن تسجيل المعطى خاص في المعنى الكلي؟
يعتمد هذا الأمر على قرار الشخص بأن يكون حرا و الاعتراف للأخر بأنه «أنا أخر». فالانتقال من العالم الإغريقي-الروماني المنقسم إلى العالم الجرماني الموحد قام على إرادة المواطنين في الدول الجرمانية اعتبار الناس جميعهم أحرارا. والحال، أن لا شيء في الواقع يمكنه منع هذه الإرادة لأن الإلغاء عملية فكرية محضة لا تقوم على تحويل المعطى الواقعي وإنما تمنحه معنى جديدا وعلى وضع قاعدة مشتركة : «فالفكر هو السلب الموثوق الذي يذيب جميع الحتميات ويحذف فيه كل ما هو موضوعي أو كل ما هو كائن».
فعلى سبيل المثال، فإن انتصار الاغريق على الفرس، انتصار «الحرية الجميلة»على الاستبداد يفسره اختلاف في التهيؤ الروحي. بين فرس طائش يقوده ملك تحركه رغبات فورية و إغريق متطلع إلى الحرية الموضوعية. فانتصارا مارثون و سلامين يجد كانا انتصارا لإرادة مستقلة على أرادة مستلبة. لذلك، فإن الكلي يفوز دائما على الخاص لأن مهمته هي أن يحكمه ويجعله تابعا له. ويمكن القول بأن القاعدة الكونية لا تقيد المعطى الخاص، بل تحرره. ذلك أن النظام ينتصر على الفوضى عندما يقرر ذلك.
تتفاوت درجات عمل الإلغاء. فالحياة الأخلاقية مثلا تعمم الأخلاق لكنها ، كلحظة من لحظات الروح الموضوعية، تبقى مشوبة بالتناقض. وبالمثل، فالعالم الجرماني يلغي العالم الإغريقي-الروماني لكنه يبقى محدودا تاريخيا مقارنة بالتاريخ العام. أي أن عملية الإلغاء لا تحول الشر بالفعل إلى خير وتتيح، فقط، لمنظومة أسمى وأخير التصالح مع منظومة سيئة أدنى. فهل هذا يعني بأن الشر معني بالمصالحة؟
لنأخذ الانتقال من المجتمع المدني، كمجتمع تحركة المصالح الأنانية، إلى الدولة كمؤسسة توحد اعضاءها بوعي مدني. فالدولة، من وجهة نظر هيجل، لا تنهي التفاوتات الاجتماعية بتخلي البورجوازية عن الدفاع عن مصالحها الخاصة، ولكنها تفرض نفسها كنطاق مبتكر، هو نطاق الفعل السياسي الذي يلتزم أخلاقيا بمراعاة المصلحة العامة. فالانتصار على الشر لا يعني تحويل الشر إلى خير بقدر ما يعني بناء الخير على أسس سليمة وإخضاع الشر الذي في نطاقه و هزيمتة في نطاق اللحظة اللاحقة . وهذا يعني أن الشر يعتمد كأداة ينكشف بها الخير ذاتيا، اداة يتخلى عنها وتترك لمصيرها.
لكن، ما مسؤولية الإنسان على الشر؟ هل الشر شر ميتافيزيقي لا يتحمل الإنسان المسؤولية عنه؟
لا يمكن للإنسان أن يتخطى زمانه، ويفكر ويتصرف بخلاف روح مجتمعه . ومع ذلك، فهو الذي يقرر الخضوع لقوانين دولته. لذلك، لا يمكننا القول بأن تناهي الإنسان مجرد أمر واقع لا مناص منه. فالمواطن الروماني لا يمكنه أن يتموقع في زمن الروح الجرماني – المسيحي، ولكنه قادر على إدراك أوجه القصور والعنف في زمنه لتأثره بها ضرورة:
«بما أن الشر يكمن في المفهوم (المبدأ الداخلي)، و نظرا لضرورته، فمسؤولية الإنسان الأخلاقية تنتفي كلما استولى عليه الشر، ومع ذلك فالإنسان هو صاحب القرار، قرار حريته ومسؤوليته الأخلاقية».
عند موت جندي فارسي أثناء غزو الاسكندر لأسيا، فموته، من وجهة نظر هيجل، موت عادل لأنه يعبر عن هزيمة الاستبداد الشرقي، الذي يعتبر الجندي الفارسي، فرضا، متضامنا معه، في مواجهة «الحرية الجميلة»، التي يفترض بأن هذا الجندي معارض لها. لهذا علينا «أن نكف عن ترديد كلام المؤرخين: لو لا نهر الدماء لكان الاسكندر عظيما. علينا أن ننتهي مع خطاب الحرب والدم عند تناولنا للتاريخ العالمي، فبهما يكمل روح العالم تقدمه»
نفس الفكرة نجدها في تحليل هيجل للذنب التراجيدي حيث يتحمل الأبطال مسؤولية مأساتهم رغم أن نشاطهم ضروري من الناحية الأخلاقية: «في التراجيديا الحقيقية ، على كل من القوتين الأخلاقيين اللتين في الصراع أن تتمتعا بالشرعية». فالبطل يتصرف باسم القوانين العادلة و لا يكون مرغما أو جاهلا بما يفعله. وأي محاولة لتبرئته تعد سبة في حقه: « الذنب شرف العظماء»
يوجه انتقاد معتاد لمؤلفي الثيوديسا نظير لامبالاتهم بالضحايا. ويبدو بأن هيجل يتبنى نفس الموقف: «لا يمكن للعقل أن يتوقف عند ما يصيب الضحايا لأن الأهداف الخاصة تضيع ضمن الهدف الكوني». وفي هذا الصدد، يجب أن نبرز نقطتين:
أ). إن الحكم أعلاه حكم ينبع من الممارسة الفلسفية كممارسة نوعية. فمهمة الفلسفة بالنسبة لهيجل لا تهتم بالمشاعر أو الحالات الخاصة لأنها فكر نظري يراهن على الكوني؛
ب). إن التأمل يقوم على تعميم المشاعر الخاصة وإدماجها في نظرية عامة. لذلك يبين هيجل هشاشة الأفراد والشعوب وفسادهم مما قد يعيق تقدم الحرية.
فيما يتعلق بقضية الموت. يجب التفريق بين موت الأفراد، وهو مأساة حقيقية لكنها عادية، عن موت الأبطال الذي تفسره أسباب تاريخية: «والحال أن الرجل النبيل والعظيم يرفض الشفقة التي تعرض فقط الجانب السلبي للمأساة حيث يذل التعساء». غير أن هذا لا يعني بأن هيجل يستهين بالموت «العادي» بقدر ما يعني أن الموت «التاريخي» يحتاج خطابا من مستوى آخر. فالموت التاريخي يحيل على صراع المشروعية. فالجندي الفارسي، خلال الحروب الميدية، يموت مذنبا لتضامنه مع الاستبداد، أما الرجل العظيم فيموت لأجل مشروعه السياسي. هنا، يكون للشفقة معنى. لا رثاء وإنما اعترافا بقيمة المصاب: «الشفقة الحقيقية هي […] التعاطف […] مع المشروعية التاريخية لمن يعاني، و مع ما يمتلكه من مزايا إيجابية وجوهرية». فنبل المشاهد ، حسب هيجل، يقاس بالنظر إلى موضوع اهتمامه. إذ أن النبيل يتأثر فقط بالمحتوى النبيل، أما الوغد فيتأثر قلبه بأي محتوى بذيئ.
ومع ذلك، فالموت -في الحالتين- فدية التناهي ، ليس كعقاب، الذي هو مصدر الموت والموت هو من ينهيه. فليس علينا ، بالتالي، أن نذرف الدموع على الموت أكثر من الولادة التي هي المدخل إلى التناهي، المأساة الحقيقية. تتضح هذه الصورة المأساوية للتناهي في نصوص هيجل عن المسيح التي يستلهم فيها كثيرا رسالة القديس بولس إلى اهل « فيليب»: الصليب هو الصورة الأكثر تطرفا للتجسيد ، المأساة الأصلية في نظر هيجل: «فالله هو من يعاني في حلوله البشري حيث يكون سجينا داخل هذه الحدود الثابتة».
يعترف هيجل بأن قيمة الشخص – المسؤولية و الحرية و الإرادة و الفعل – هي المحرك الأساسي لتقدم التاريخ.لذلك، يجسد العالم الجرماني اكتمال التاريخ لأنه يعترف بالقيمة اللامتناهية لكل إنسان.: « في حدودها و في دواخلها، يمتلك التدين و الأخلاق في حياة محدودة -حياة الراعي و الفلاح – قيمة لا متناهية تساوي القيمة التي لتدين وأخلاق من له معرفة كبيرة وغنى وجود في علاقاته وأعماله. هذا الداخل، هذه المنطقة البسيطة التي يوجد فيها الحق في حريتنا الذاتية، حيث الإرادة والقرار والفعل […] فيها تكمن مسؤولية وقيمة الفرد وحكمه الأبدي».
يقع الظلم، تبعا لذلك، عندا يقتل الفرد لأجل مبدأ وضيع -عندما تتحكم الطبيعة في الفكر والإرادة، وعندما تعلو المصالح البورجوازية على المصالح الوطنية، عندما هزم الفرس الاغريق، عندما تصبح الفلسفة شكلا أدبيا …و مع ذلك، فحين تريد الروح يخضع تناهيها ومحدوديتها: « ماقد لا يستوعبه المفهوم [ المبدأ الداخلي]و لا يقدر على حله و تجريده، هو ما سيقف أمامه ويمزقه ويتعسه». [ومع ذلك] فإن المفهوم يذيب كل شيء وقادر على تكرار الإذابة باستمرار»
العزاء الفلسفي
ترتسم أمامنا الخلاصات التالية:
- إن الخير نتيجة إذن. إذ توجد في النسق الموسوعي، لحظة تتحقق كنتيجة، يتعلق الأمر بالروح التي جوهرها الحرية والحقيقة، بخلاف الطبيعة «التناقض المعلق»، «انحلال الفكرة» التي «يحكمها الاضطراب الخارجي». يثني هيجل على الروح على حساب الطبيعة لأن موجوداتها نسبية. فالروح، حتى في أعمالها المكروهة ، صانعة نفسها تتمتع بالمشروعية وتستحق الثناء. لا
- وجود لخير محض في نظر هيجل لأن إقامة الخير تتم بمحاربة الشر واحتوائه. إذ أن ذات اللحظة تقبل الخير من اوجه والشر من أوجه. فداخل أي مشروعية سياسية رئيسة تمأسس الإرادة الشعبية، مثلا، يقع الانتقال من إرادة غير شرعية إلى إرادة شرعية قائمة على سلطة متقاطعة؛
- على هذا الأساس، يمكن اعتبار فلسفة الروح فلسفة محافظة وتقدمية في نفس الوقت. فهي محافظة لأنها تعتبر الروح يتحقق ذاتيا كنتيجة ، وهو بذلك خير في جوهره وبريئ من أية إدانة، وهي تقدمية مادام أن كل لحظات الروح تتقاطع فيه و تبدأ بمرحلة نقص ولا تبلغ حقيقتها إلا في النهاية. أي أن خيرية الروح كلية ولكن هذه الخيرية ليست فورية وإنما تاريخية، خيرية تتراتب فيها المستويات . فالروح جوهرها الخير و يلحقها الشر بالعرض فقط.
- للخير أولوية على الشر. فتقدم الأديان في التاريخ، رغم ما فيها من غرائب وجوانبها المتوحشة، يعبر عن الحقيقة. وعلى الفلسفة فقط أن تعترف بمشروعية مبادئها: «أن نتصالح مع ما ارتبط [بتاريخ الأديان] من أمور مفزعة و عبثية، و نبرره و نستحسنه ونصدقه (مثل التضحية بالأطفال و الرجال) أمر غير مقبول ؛ أما أن نعترف لها، على الأقل، بالمبدأ وببعض ما فيها من إنسانية […] فتلك هي المصالحة الاستثنائية».
على هذا الاساس، فإن التامل الفلسفي يبحث عن الترضية بالمعنى الذي يعلن فيه بأن الإنسان يستطيع تعطيل التأثيرات الخارجية ليخضعها لإرادته المستقلة والتوافق مع ذاته: «هكذا ، فسوء الحظ الذي قد يتعرض له لا يدمر توافقه الروحي وطمأنينته النفسية». لذلك، فجوهر الروح ، عند هيجل ، هي الحرية والاستقلالية التي منها يستمد مشروعيته رغم ما فيها من تناهي و شر.
ومع ذلك، فإن المصالحة الحقيقية تأتي من الفلسفة حصرا باعتبارها أخر لحظة في مسار النسق: « تصنع[الفلسفة] بالتأكيد المصالحة الحقيقية، لكنها تبقى مصالحة في عالم الفكر لا في الواقع».
«تنشأ إزاء عالم الظواهر مملكة تمثل الحقيقة الفعلية، لكنها حقيقة غير ظاهرة كقوة تشكيلية و كروح لعالم الظواهر. فالفكر يصالح ماهو حق مع ما هو واقع في مستوى التفكير فحسب»
ففلسفة التاريخ، على سبيل المثال، تفكر في التاريخ كوحدة رغم كونه مركبا. ففلسفة التاريخ تسجل المادة الموضوعية والمنقسمة في الذاتية المفكرة بصيغة موحدة. وهذا يعني أن الفلسفة تعيد تشكيل المتناهي في الفكر اللامتناهي:
« لا يمكن للعقل أن يتوقف عند الإصابات الفردية ، فالغايات الخاصة تضيع في إطار الكوني. فهو ينظر إلى العمل البشري الكلي من النشاة إلى الموت».
تعتبر الفلسفة ثيوديسا لأنها تتصالح مع موضوعها ، مثلما هو حال لحظات الروح لكن فقا لنمط خاص بها. وهو الأمر الذي به تدرك السلم مع نفسها: «فالفلسفة عموما هي الثيوديسا الحقيقية […]، فهي تصالح الروح وقد أدركت نفسها في حريتها وغناها الفعلي». هذا الموقف التصالحي الذي يفهم الموضوع و لا ينكر قصور ه ويتهرب من المتاعب وعدم الرضى، تقليد فلسفي نجده مثلا عند اسبينوزا: « حرصت كثيرا على اكتساب معرفة حقيقية بالناس بدل لسخرية والبكاء على هذه الأفعال وكراهيتها»، أو عند فشته: « لا تنتظروا مني، لا نبرة الشكوى أو القدح، أو حتى الهجاء الشخصي. فلن أشتكي لأن أجمل مكافأة للتفكير الفلسفي هي أن ندرك بأن كل ما يوجد ضروري وخير. فما دام كل شيء، بالنسبة للتفكير الفلسفي، يوجد داخل سياقه ، فيجب عليه، إذن، أن يتوافق معه و يتلائم كما هو».
في التاريخ باعتباره لحظة الروح الموضوعية، يتحقق المبدأ الجامع في الموضوع المنقسم بطبيعته لأن الأمر يتعلق بشعوب عديدة. أما في الفلسفة، لحظة الروح المطلقة، فيتحقق المبدأ -الروح الفلسفية- في الذات الجامعة بطبيعتها. إذ أن هيجل يعتبر بأن الفعل الفلسفي يتحرى الموضوع من داخله بواسطة الروح الفلسفية. صحيح بأن الموضوعات تتعاقب، غير أن الفلسفة لا تقسم لأنها تمارس التغيير من داخلها . و بالمقابل نلاحظ تعدد الشعوب المتصارعة في التاريخ. باختصار، فالروح المتفلسفة تجعل ذاتها موضوعا لنشاطها، في حين ينقسم روح العالم إلى كائنات متمايزة. بصفة عامة، فإن المجموع الخارجي يتحيز في الروح الموضوعية ، الجمعية، في حين أن الروح المطلق محل الجمع الداخلي. الأول صراعي و الثاني مسالم.
هل يمكننا، أساسا، اعتبار الفلسفة الهيجلية ثيوديسا، فلسفة «تدافع عن الحكمة السامية لخالق الكون» على اساس أن هذا العالم هو افضل العوالم الممكنة، و تسعى إلى تبيان وجه الخير في الشر، و أن التاريخ البشري يكتمل جماعيا؟
فيما يتعلق بفلسفة التاريخ الهيجيلية، فالمصالحة المطلقة لا تكتمل في التاريخ باعتباره لحظة الروح الموضوعية، لأن خصوصية الشعوب لا تقبل التجاوز. فلا وجود، بالنسبة لهيجل، لشعب عالمي لأن كل شعب يدافع عن مصلحته الخاصة بدافع من أهواء البشر : « فالفضلاء و النبلاء يجتثهم التاريخ: أفسدته أهواء البشر». لذلك، يصبح الانتقال إلى الروح المطلق أمرا ضروريا.
تعنى فلسفة هيجل بالتكفير في ما هو كائن ولا تدافع عن هذه القضية أو تلك لأن غاية الفلسفة ذاتية تسعى إلى التفكير الملائم، أي التفكير بكل حرية.
لا تدعي فلسفة هيجل بأن ما وقع لم يكن ليقع لأن التاريخ لا يخضع لضرورة عمياء ولا ينكر وجود الشر- الطارئ الذي لا يقبل الغفران. غير أنها تتصالح مع الشر في سياق معرفة حرة: «يجب علينا أن نستوعب الشر في الكون، بما في ذلك الشر الأخلاقي، وعلى الروح المفكرة أن تتصالح مع السلبي». إن انتصار الخير نسبي دائما لأنه لا يبطل الشر و إنما يدمجه داخل معنى صادق مع ذاته. لن نستطيع، بحسب هيجل، أن ننزع الشر من الواقع فهو أساس وجود المؤسسة الروحية، من جهة، ولاشيء يمنع ، من جهة أخرى إقامة الفكراني ، فالمصالحة تتم في ملعب المعرفة و الإرادة فحسب.
أين تختلف ثيوديسا هيجل عن ثيوديسا لايبنز؟
أ) ليس الشر عند هيجل أمرا ثابتا وكأنه قضاء إلهي قبل خلق الله للكون، لأن الشر بالنسبة له نسبي وإجرائي (سيروري) يرافق، في سياق أي دورة منتظمة فترتي الفورية و القطيعة؛
ب) أن انتشار الخير لا يقتضي الصعود نحو الله و إنما النزول إلى الذوات الفاعلة في العالم و عملها. فأولوية الخير تدرك في سياق التجربة ولا تدرك في مستوى النظر المجرد للأشياء. لذلك، ففلسفة هيجل لا تبرر وجود الله في صيغة منطقية وإنما بالتفكير في السيرورة الملموسة التي يغلب بها الخير الشر؛
ج)لا يبرر هيجل، في الأخير، حدوث الشر مطلقا. فالشر ليس له أي سبب وجود، ولذلك، فلا يمكنه فعل شيء ضد الخير. صحيح أن التناهي أمر سيء، غير أن المصالحة أكبر منه.

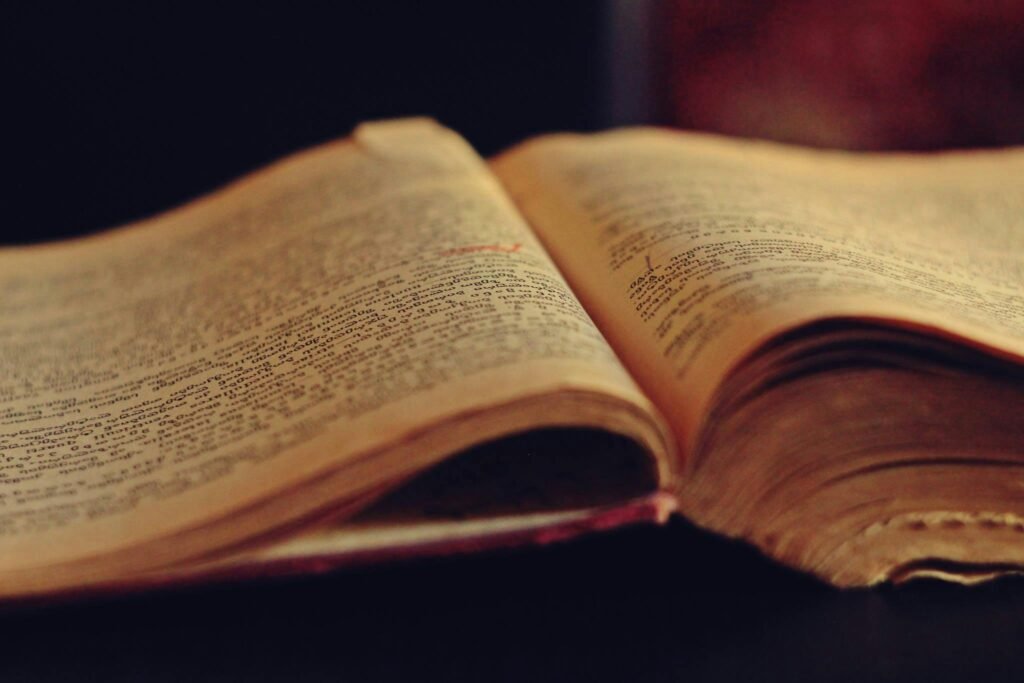
No responses yet