إشكالات التأويل في السياقين العربي و الغربي
مقدمة
يمكن القول بأن التأويل مفهوم ملتبس بالنظر إلى اختلاف القول في تحديد دلالاته و حصرها في معنى متفق عليه. و في هذا السياق يمكننا أن نميز مثلا التأويل الفقهي و الفني و الترجمي و القانوني و الفلسفي.
فالتاويل في الفلسفة مثلا يعنى بتأويل حضور الإنسان في العالم و أبعاد هذا الحضور المعرفية و الأيديولوجية و التاريخية. لذلك قد يتخذ التأويل دلالة معرفية بفرضية أن كل معرفة تنبني على بنيات ذهنية قبلية تحكم مداركنا وتوجهها، أو دلالة أيديولوجية بفرضية أن رؤيتنا للواقع ترتبط دائما بمصالح صريحة أو مستترة، أو دلالة تاريخية بفرضية أن أي تأويل هو ابن زمن خاص بمفاهيمه و معاييره و سلم قيم خاص. غير أن التأويل عادة ما يرتبط باللغة لأن هذه الأخيرة تحتضن كل ما يقبل التأويل.
يعتبر جياني فاتيمو أن عصر ما بعد الحداثة ينتصر لفكرة أنه لا توجد وقائع و إنما تأويلات فقط، أي أن التأويل كوني سواء نظرنا إليه من وجهة نظر غادمير أو هايدغر. فهذا الأخير يرى بأن الإنسان كائن تأويلي لأنه يواجه الموت و العدم و التأويل يساعده على تطويعهما. يقول هايدغر في درس قدمه سنة 1923 بأن تأويلية الإنسان ترتبط ب:
- قدرته على التأويل؛
- و حاجته إليه؛
- أن رؤيته لذاته و للعالم يحددها تأويل خاص.
- ( Voir M. Heidegger, Ontologie. Herméneutique de la facticité, cours du semestre d’été, Œuvres complètes ((Gesamtausgabe), t. 63, p. 64.
لذلك فالتاويل مشروع وجودي يكون أصيلا كلما صيغ بعبارات واضحة و كاشفة و يكون زائفا كلما تم استمد عباراته من المشترك المهيمن والسائد.
أما غادامير فيقرن، من جهته، كونية التأويل بالشرط اللغوي لأن “الكائن الوحيد الذي يقبل الفهم هو اللغة” ويقصد بذلك أن المعنى أو الموضوع يدركان من خلال حاملهما اللغوي.
تندرج فلسفة التفكيك لجاك دريدا ضمن نفس التصور القائل بكونية التأويل رغم أنه يتبنى موقفا شكيا وتفكيكيا بتأكيده على أن المعنى لا ينكشف دائما بتأويل اللغة. فقدر اللغة أنها رهينة في امبراطورية الرموز بقدر ما هي قادرة على تنويع التأويلات إلى ما لا نهاية. و بناء عليه، يميز دريدا بين استراتيجيتين تأويليتين تمتنعان عن أي مصالحة:
- استراتيجية حالمة تبحث عن فك شفرات حقيقة أو أصل منفصلين عن نظام الرموز؛
- استراتيجية لا تبحث عن الحقيقة و تقبل باللعب اللغوي. و هو ذات القبول- في نقد نيتشه- الذي يجعلنا نؤمن بعالم بريئ، خال من الخطأ، لا حقيقة فيه و لا أصل، عالم متاح للتأويل المستمر.
أما بول ريكور، فقد ميز بي مقاربتين تأويليتين كبيرتين يرتكزان أساسا على موقف المؤول. يتعلق الأمر بهرمونطيقا الشك و بهرمونطيقا الثقة. إذ أن الأولى تتوجس من المعطى اللغوي بدعوى أنه يمر دائما عبر وساطات إيديولوجية و مصالح خفية يمكن للتأويل الريبي أن يكشف عنها -هذا النوع نجده عن نيتشه و ماركس وفرويد و فوكو ودريدا-، بينما تثق المقاربة الثانية في المعنى المعطى لأنه يعبر عن قصد أو ذكاء يقبلان الاستدلال و التفكير.
أولا، إشكالات التأويل في الفكر الغربي
أن نؤول نصا من النصوص، أن نترجم، أن نطبق قانونا أو أن نحيا في خضم رؤية للعالم خاصة، أمور تفرضها حقيقة واحدة، و هي أن المعنى يقصد وسيطا و يتطلب نقلا. فنحن لا نفهم النص أو العمل الفني أو اللغة الأجنبية أو القانون أو العالم بدون أن نبني المعنى بهذا الوسيط او الناقل. فالفعل اللاتيني inter-pretatari فعل متعدي، أي فعل يقوم به الفاعل و ينفعل به في الوقت نفسه. فنحن عندما نؤول و نتلقى معنى مؤولا لما يريد النص، أو اللحن أو القانون أو الترجمة أو العالم، أن يبلغه و يقوله. و هنا تبرز مشكلة أساسية للنظرية التأويلية. في أي موقع يجب أن نتموقع؟ هل في موقع الذات التي تؤول أم في موقع المتلقي؟
فإيميليو بيتيEmilio Betti (Voir E. Betti, Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre (Pour fonder une doctrine universelle de l’interprétation), 1954, nouvelle édition Mohr Siebeck, Tübingen, 1988, p. 21.) يلح على أن المعنى يجب أن ينكشف من خلال النص لا أن يسقط عليه. وهذا خلاف مسلك نيتشه و هايدغر و سارتر و جيل دولوز و الهيرمونيطيقا المعاصرة التي تؤكد بأن التأويل عملية منتجة للمعنى. هذه العملية ترجع أصولها إلى فلسفة الذات، من ديكارت إلى كانط، و التي تنظر إلى الإنسان باعتباره عقلا يلتقي بعالم فوضوي يجب أن ينزع عليه الوحدة والنظام بمساعدة بنياته و مفاهيمه. و بالتبع فإن العملية التاويلية تبحث عن المعنى في مقامات نصية متعددة و متناثرة و في عالم مفتقر إليه. وبعبارة أخرى، فإن العالم بدوننا ليس إلا كتلة جامدة وصامتة و نحن من يمنحه المعنى الذي يسمح بتأويله تأويلات مختلفة. لذلك يتم التركيز على المؤول أكثر من التركيز على الموضوع.
غير ان السؤال المطروح هو: من أين يصدر المعنى الذي نضفيه و ندخله إلى العالم؟ من العقل أم من اللغة؟ من الأيديولوجيا؟ من الميتافيزيقا؟ ماهي الحمولة الأنطلوجية للتأويل، علاقته بالوجود السابق عليه و الذي بسببه يغدو ممكنا؟
ولعل في اكتشاف العلم المعاصر للتركيب الرقمي للخريطة الوراثية للإنسان مثال يوضح هذا الإشكال. أليس الموضوع معطى قبلي (الخريطة الوراثية) و التأويل معطى بعدي (التركيب الرقمي؟ أليس واضحا أن هذا التأويل يعبر و يترجم شيئا موجودا، لغة تترجم الشرط الوراثي للإنسان؟
صحيح أن النظريات العلمية نظريات تقريبية و فرضيات قابلة للتكذيب ولكنها تبقى ذات معنى بالعلاقة مع الموضوع الذي يقبل التأويل وليس مع الذات المؤَوّْلة. وبعبارة أخرى، إذا كان المعنى يظهر في الغالب في سياق إسقاطه الذاتي و الاعتباطي فعلينا ألا ننسى بأنه يؤخذ من الأشياء و الموضوعات كذلك.
يقال غالبا بأن التأويل يعنف النص أو العمل أو يقتله لأنه يطغي الذات عليه إلى الحد الذي قد يستبدل النص و العمل نفسه. فقد يتعلق الأمر بإنتاج جديد و ذو قيمة إلا أن ذلك قد ينسي التأويل وظيفته الأولى، وظيفة الوساطة و النقل. فقد كان غادمير يقول أحيانا بأن التأويل الناجح هو الذي لا يعوض النص و يختفي داخله.Voir Hans- « Quel est donc le cri- tère d’une. نجد هذا الأمر في المسرح و السينما: فالممثل الذي يستطيع تقمص شخصيته بشكل رائع لا يدهشنا بالاداء و إنما لأننا نعتقد باننا امام حضور حقيقي للشخصية موضوع التمثيل. والأمر نفسه نلفيه في الفن التشكيلي، حيث نلتقي بالموضوع مباشرة و بشكل أفضل مما قد يدلنا عليه نص أو صورة فوتوغرافية. وهذا يعني أن التأويل الناجح، مثل الترجمة الناجحة، هو الذي لا يشعرنا بأننا بإزاء تأويل، أو ترجمة، إنه التاويل الذي لا نلاحظ فيه السينمائي و لا الممثل و لا الرسام و لا الموسيقي و لا المترجم و لا المؤَوّل.
إذن، يجد المؤول نفسه متأرجحا بين قطبين، عليه معرفة الموازنة بينهما: قطب موضوعي وقطب ذاتي. و هو أمر يتضح في التأويل الفقهي Philologique و الفني حيث يمر إدراك النص بذات المؤول بالضرورة.
إشكالات التاويل في الثقافة العربية
يمكن القول بأن الثقافة في المجال العربي-الإسلامي ترتكز على النص القرآني. وهو الأمر الذي سيطرح مشكلة التأويل بقوة بدليل وجود تأويلات كثيرة للنص القرآني الذي ألهم ويلهم ملايين الناس عبر العالم. غير أن التأويل يطرح مشكلات كثيرة:
هل يقبل النص القرآني التأويل؟ ألا يؤثر التأويل على الرسالة الإسلامية و كونيتها؟ كيف نفسر الاختلاف و الافتراق حول تأويل النص الديني؟ هل يمكن بناء منهج يقود إلى التأويل الصحيح له؟
التأويل عند ابن رشد
قد يكون ابن رشد المنظر الأكبر لمنهج التأويل في التعامل مع النص الديني في السياق الثقافي العربي- الإسلامي.
فرغم أنه ظهر في بلاد الإسلام عدد من الفلاسفة بين القرني الثالث عشر و الخامس عشر من ابن سبعين الأندلسي إلى الملا سدرا الفارسي، فإن ابن رشد (1126-1198) يعد أبرزهم و أقْدرهم، في نظر المؤرخين، بالنظر إلى قيمة مشروعه واثره في الغرب اللاتيني في القرون الوسطى و الحديثة خصوصا.
يقوم المنهج الرشدي على القياس و ليس على الجدل الذي كان ديدن الفقهاء. بميز ابن رشد بين ثلاثة سبل في الخطاب و الدعوة إلى الحق وهي الخطابة و الجدل و البرهان. أي أن الحق واحد وسبل إدراكه ثلاثة على الأقل وإن كان سبيل البرهان/الحكمة أولى و أوثق. و كون النص القرآني دالا على الحق فكيف نستخرجه منه و نستدل عليه خاصة عندما يقع التعارض بين العقل و النقل؟
يبين ابن رشد أمرين:
- ما دام أن البشر مخلوقات إلهية فإن الله يهب العقل لكلهم- و في هذا يختلف ابن رشد عن الفلاسفة اليونان الذي خصوا العقل للإنسان اليوناني و نفوه عن العبيد و المتوحشين. فالعقل عند ابن رشد متوزع بين الناس بالتساوي-فإن الله يستحيل أن يخاطب الناس بما لا يعقلون و أن يتعارض، بالتالي، النقل/الوحي مع العقل. فقط أهواء و التباس الفقهاء هي من يفرق بين الناس و يمنعهم من اتباع عقولهم؛
- أن الرسالة الدينية رسالة عقلانية شأنها في ذلك شأن الممارسات العقلية الأخرى التي تختلف عنها من حيث أشكال التعبير.
يقدم ابن رشد القرآن الكريم في مقدمة كتابه “فصل المقال” كنص معرفي و نص يحث الناس على المعرفة. و في هذا توسيع لأفق المعرفة القرآنية و عدم حصره في الأفق الشرعي فقط.
يعتبر القياس هو الوسيلة التي بها يستنبط المجهول من المعلوم و يستعلم. ويميز فيه ابن رشد بين القياس بالمثال و القياس بالبرهان الذي به تَخْلُصُ المعرفة بالوجود الكامل: وجود الله. كما يفرق ابن رشد بين القياس العملي و القياس النظري.
ففي مجال التشريع تطرح مسألة تعميم الأحكام و القواعد الشرعية على الحالات المختلفة و المتعددة. وهذا يعني أن القياس ليس مجرد تأويل و إنما هو منهج في التعامل مع القضايا المستجدة التي قد تتحدى النص و ليس معنى النص فحسب. فمثلما أن الميتافيزيقا تتحدث عن الجوهر وعن أعراضه بعد ذلك، فإن الشرع متضمن لقوانين يقوم القياس بالمماثلة، بعدها، بتخريج الأحكام الخاصة بشرط رد الحالة الخاصة و المستجدة إلى القاعدة العامة.
يتأسس القياس الشرعي على أربعة مكونات:
- الحالة القاعدية؛
- الحالة المماثلة؛
- القرينة أو وجه الشبه و المماثلة؛
- الحكم.
هذه العناصر تحكمها آلية النقل، نقل الحكم من الحالة الأصلية في النص القرآني أو الوحي إلى الحالة التي تماثلها (الحالة المستجدة) عندما يشتركان في القرينة أو السبب. فالحد الأوسط في القياس هو السبب أو القرينة في المماثلة، و علاقة الحد الأوسط بالحدين الأدنى و الأكبر هي نفسها العلاقة التي تربط القرينة بالحالة المماثلة و الحالة القاعدية.
و عليه فإن النص المقدس في أفقه الشرعي أو التاملي يحث على استعمال مناهج تحري يقوم بها العقل بدور رئيسي. فهذا النص موجود ليقرأ قراءة منهجية تحتضنه بالمقام الذي يليق به.
في الحاجة إلى التأويل
لكن، و قد ظهر بأن العقل ضروري في المعرفة الشرعية و في النظر الذي بها تستنبت معارف جديدة و يستدل به على المعرفة المنقولة في الوحي، فماذا نفعل في حال التعارض بين النقل و العقل؟ فإذا كنا نجد في القرآن، مثلا، آيات تؤكد بأن كل ما في الكون مقدر و أن الإنسان مسير لا مخير، و كنا نجد، بالمقابل، آيات أخرى تؤكد على الاختيار الإنساني، فكيف ندبر امر هذا التعارض؟ هل بالافتراق إلى نحل و ملل؟ ألا يتعارض الافتراق مع الأمر القرآني بالامتناع عنه؟
يتبنى ابن رشد موقفا يثبت به التوافق بين الحرية و الحتمية لأن الله خلق فينا القدرة على كسب الأفعال المتناقضة (الخير والشر) وأن هذه القدرة لا تتحقق إلا بالتوافق مع الأسباب الطبيعية و ليس بالتعالي عليها. هذا الموقف التوفيقي يعبر عن تأويل عقلي يرفع به بن رشد التناقض الظاهر داخل النص القرآني. تناقض أخذت به كثير من الفرق في الإسلام فاختلفت و افترقت بين جبرية و قدرية و غيرهما. أي أن التأويل الرشدي يحل مسألة الاختلاف و الافتراق ويؤسس للوحدة لأن الشريعة واحدة و الدليل عليها الحكمة أختها الشقيقة “فالحق لا يضاد الحق و إنما ينصره و يشهد له”. فالتأويل ضروري لأهل النظر “لأنهم اقدر عليه و أحق باستخدامه”. و معنى التأويل عند ابن رشد هو “إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية بغير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك…”
يقطع ابن رشد بأن” كل ما أدى إليه البرهان، و خالفه ظاهر الشرع، أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي”.
خاتمة
قد تختلف الإشكالات التي يطرحها التأويل بين الثقافة العربية و الغربية إلا أنه يبقى ضروريا بالنظر إلى حاجة الناس إليه و قدرتهم عليه ولأن وجودهم و معرفتهم و قيمهم و سلوكاتهم تتحدد به.

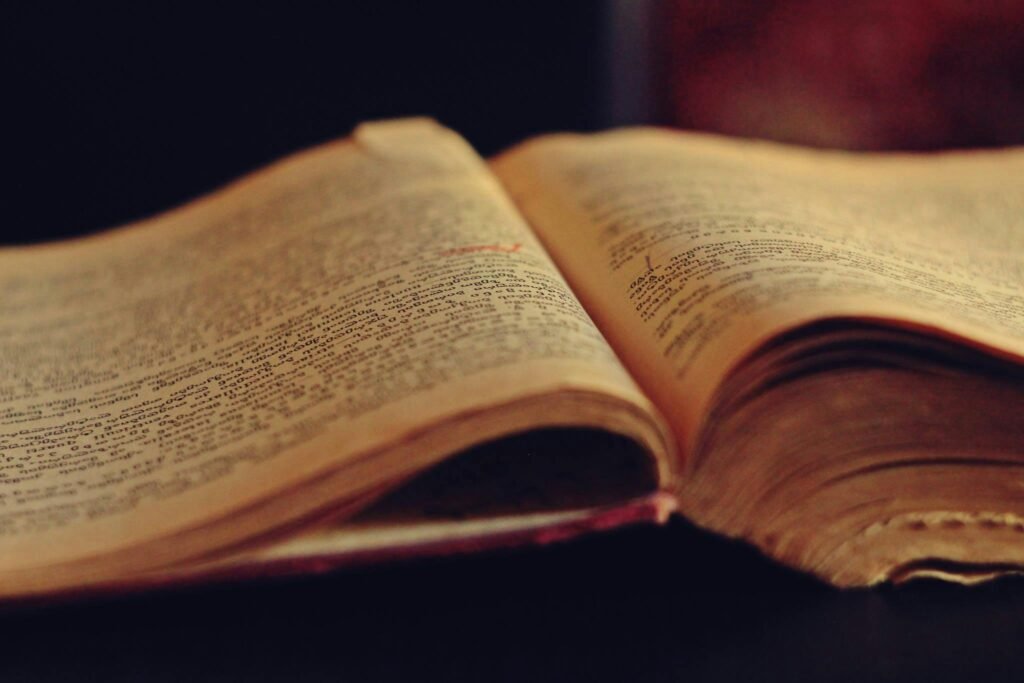
No responses yet